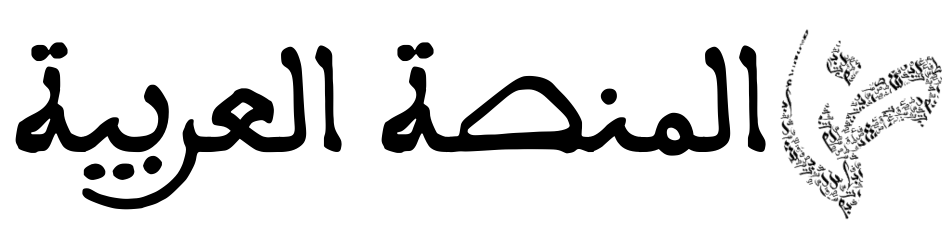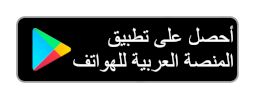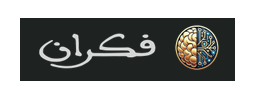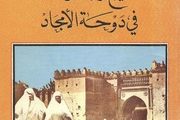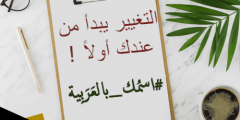في القرن الحادي والعشرين، أصبح التوازن بين الديمقراطية والدين تحديًا متزايدًا، خاصة في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة حيث الدين جزء أساسي من الهوية الثقافية. هذه المجتمعات تسعى لتحقيق الحكم الذاتي الديني ضمن نظام ديمقراطي، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع الاختلافات الفكرية ورسم الحدود القانونية لهذه الاختلافات. الديمقراطية، المبنية على الحرية والتعددية، تؤكد حق المواطن في اختيار معتقداته بحرية، ولكن عندما تتداخل هذه المعتقدات مع قضايا مثل الشريعة الإسلامية التي قد تتضمن قوانين غير تقليدية بالنسبة للمجتمع الغربي، تصبح المشكلات أكثر تعقيدًا. إحدى الحلول المقترحة هي إنشاء مدن أو مقاطعات دينية تتمتع باستقلال ذاتي لتطبيق العقوبات والسلوكيات الأخلاقية وفقًا لأديانها المحلية. من ناحية أخرى، هناك نموذج يدعو إلى المساواة تحت مظلة قانون مدني واحد ينطبق على الجميع بدون تمييز بناءً على الانتماء الديني. الحل الأمثل يبقى في الالتزام بمبدأ الحوار المفتوح واحترام الآخر، وبناء مجتمع متسامح متعدد الأعراق والثقافات والأديان يعمل بسلاسة نحو تقدم مشترك واستقرار دائم.
إقرأ أيضا:العلم الجيني يحسم «المغاربة عرب جينيا»- روفيلو بورو
- أضاف القائمون على مسجد الحي سجادة سميكة طويلة؛ فأصبح المصلون حين السجود لا يوصلون دائمًا أطراف أصابع
- فوينتيلمونغي
- فضيلة الشيخ: عند عقد زواجي لم يلقنا المأذون الإيجاب والقبول، لكنه قام بكتابة العقد، ثم قرأه علينا، و
- هل تجوز قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بنية الاستشفاء، بالإضافة إلى نية التعبد بها، وأنها ركن أساسي في