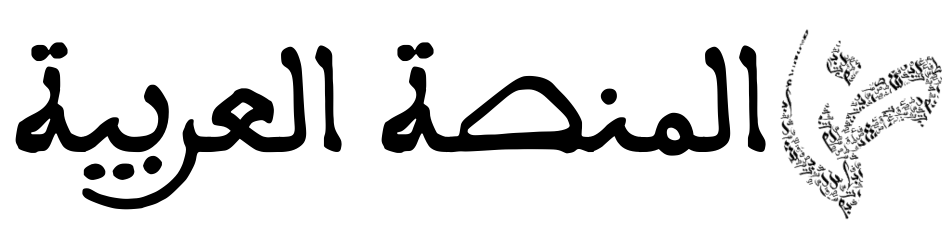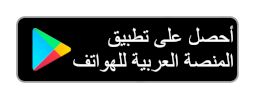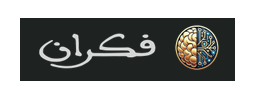تعود جذور الشعرية العربية إلى العصور الأولى للإسلام، حيث كانت النصوص الشعرية وسيلة للتعبير عن الانتماء الثقافي والاجتماعي للشعراء والقبائل. اعتمد النقد العربي التقليدي على تسجيل وتدوين هذه الأعمال الأدبية وفقًا لمبادئ زمنية وبُنية حياتية بدوية، مما أكسب اللغة العربية مكانتها العالمية باعتبارها لغة القرآن. عمل علماء النقد مثل الأصمعي وابن معتز والجاحظ والمرزوقي على نشر أسس هذا الفن الغني عبر كتاباتهم العديدة حول مختلف جوانب الشعر من وزن وقافية واستخدام المجاز وأثر التصوف والأخبار العلمانية فيه. في القرن الخامس الهجري وبداية عصر النهضة الإسلامية، شهدت نظرية الشعر تطورات كبيرة حيث ظهرت مفاهيم نقدية جديدة مستندة إلى تقسيم شعر العمود ضمن ست أغراض رئيسة تشمل المدح والفخر والرثاء والغزل والهجاء والوصف. خلال العهد العثماني، بدأ ظهور منهجية أكثر تنظيماً للنقد الأدبي تحت تأثير الأفكار الأوروبية المتعلقة بالنظام العام للأعمال الأدبية. ومع تقدم الزمن واتساع نطاق التأثيرات الدولية داخل العالم الإسلامي، تطورت مجالات دراسة القصيدة بما فيها الشعرية الانشائية والدراسات التاريخية للأدب وعلم الدلالة بالإضافة لعلم النفس الاجتماعي المرتبط بالقضايا الأخلاقية والإنسانية العامة. اليوم، تكتسب الشعرية أهميتها كونها تمثل ذروة إنجازات البشر المعرفية الفردية وجماعات اجتماعية متعددة، فهي وسيلة لفهم الذات ولدراسة الآخر سواء كان حيًا أم
إقرأ أيضا:كيف تم تعريب منطقة شمال افريقيا ؟- Indira Rajan
- براندون، سون ولوار
- أنا شاب في الـ30 من العمر أحب الأطفال كثيراً، مشكلتي أني عندما أداعب الإناث الصغار ينتصب العضو الذكر
- علمت بعدم جواز إمامة صاحب العذر فجعلني هذا لا أقوم بالإمامة، وفي العمل تقام الجماعة الأولى الكبيرة و
- أقسمت بالله أن لا آكل أطعمة معينة؛ لأني أريد إنقاص وزني، وشرطت الحلف بتاريخ معين، أي: إلى تاريخ كذا،