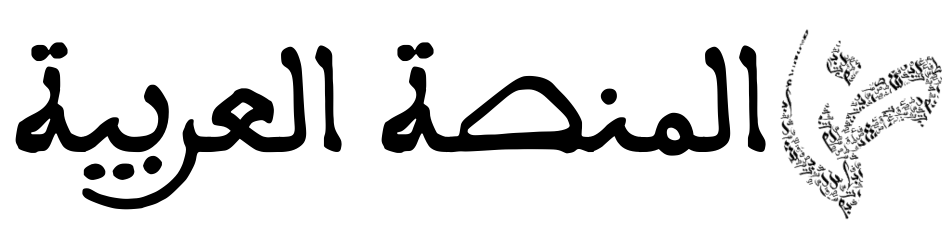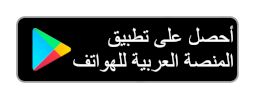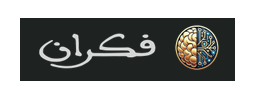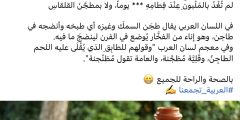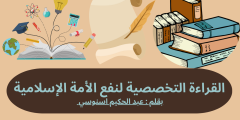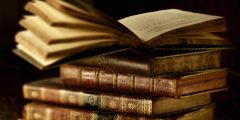يتناول النص مفهوم الدولة من منظور فلسفي تاريخي، موضحًا كيف تطورت تفسيرات الفلاسفة لهذا المفهوم المركزي عبر العصور. يبدأ بتأكيد أن الدولة هي كيان سياسي يتميز بامتلاك السيادة وإصدار القوانين الداخلية. يشير المؤلف إلى وجهات نظر متنوعة لفلاسفة بارزين مثل جون لوك ونيكولو مكيافيلي وأرسطو وكارل ماركس، وكل منهم قدم رؤية فريدة لما تمثله الدولة.
ويركز لوك على دور الموافقة الشعبية في شرعية الحكومة، بينما يؤكد مكيافيلي على قوة الاستبداد للحفاظ على النظام العام. يتناول أرسطو الأنواع الثلاث للدولة: المدن الصغيرة، والدول الكبيرة المتكونة من مدن أصغر، والإمبراطوريات الملكية. أما ماركس فيركز على أهمية الطبقات الاقتصادية والصراع بين البرجوازية والأرستقراطية كمولد للتغيير الاجتماعي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الزواقة او زوّاكةوفي السياق الحديث، ينصب التركيز على جوانب عملية أكثر للدولة، بما في ذلك الهيكل الإداري، نظام العدالة الجنائية، التعليم، التعاون الدولي، والثقافة والعسكرية. وينهي النص بالتلميح إلى الاتجاه نحو عالم موحد سياسياً واقتصادياً وثقافياً، مدفوعاً بالحاجة إلى منظمة دولية قوية وقدرة أكبر على حركة الأشخاص
- لماذا يأتي في القرآن الكريم ذكر عاد وثمود مقترنين غالباَ؟
- كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار ـ والإضرار بالبيئة محرم، والنفط ونحوه ي
- هل يجزئ صيام التطوع عن صيام الواجب، إن كان الإنسان موسوساً بأن عليه صياما واجبا؟ حتى أنه يخيل له أنه
- سان بييترو أ باتيرنو
- قست عليَّ الحياة، فعملت، واجتهدت كثيرًا، ولكني في نهاية المطاف مات قلبي من الحزن على الحال الذي وصلت